من أين تبدأ الحكاية حين ينهض الجسد ليقول كفى، وحين تقرر الصورة أن تتحول إلى ساحة صراع؟ وكيف يمكن أن تتحول الكاميرا إلى سلاح، والإطار إلى منبر، والشاشة إلى جدار يكتب عليه الغاضبون بيانهم المفتوح؟ وأي معنى يسكن سينما الاحتجاج وهي تقترب من الجمر الذي يحرق الطبقات السفلى، وتقتحم الممنوع لتفضح الطابوهات، وتعيد صياغة الذاكرة؟ يقول أحد أبطال فيلم “Z” للمخرج كوستا غافراس: “حين يغتالون صوتنا علينا أن نصير صورةً لا تموت”، وهنا يتجلى جوهر سينما الاحتجاج، التي لا تقبل الصمت أمام جور الواقع وغطرسة السلطة.
سينما من رحم الرفض
تولد هذه السينما من رحم الرفض الشعبي ومن حناجر المقهورين وهي تصدح، ومن صرخة في شوارع غارقة في الغاز المسيل للدموع، ومن العصي الغليظة التي ترمي الأجساد في شتى الاتجاهات، ومن دماء تسيل على أرصفة المدن، ومن جروح مفتوحة لمجتمعات تنكر العدالة وتوزع القهر؛ وتقترب من السياسة بحدة، وتسائل الساسة، وتخوض في الاقتصاد بجرأة، وتستجوب الأخلاق والدين والتاريخ دون أن تخشى الاصطدام، وتضع المشاهد في قلب المواجهة، حيث لا مفر من طرح السؤال المؤرق: ماذا يعني أن تكون شاهداً على الظلم؟.
وترسم سينما الاحتجاج الشعبي هويتها عبر خطابها السردي والبصري الملتصق بالواقع، إذ تنبني على حكايات مأخوذة من صلب المعاناة اليومية، وتتتبع البطالة، الفقر، التهميش، العنصرية، والاضطهاد السياسي، وأحلام الطبقات المنهوبة؛ وتسرد قصص العمال في مصانع مغلقة، والطلاب في جامعات تحاصرها الرقابة، والنساء في أحياء تخنقها السلطة الأبوية، والمهاجرين العالقين بين الحدود، وتطارد المظاهرات، وأنفاس الشوارع وتدخل الأزقة الضيقة، وتلاحق وجوه المحتجين الذين يهتفون من أجل حياة أكثر عدلاً.
وتنسج هذه السينما بنيتها الحكائية على الصراع الجماعي، حيث يتقاطع الفردي بالجماعي، وحيث يتحول البطل إلى مرآة لجماعة بأكملها. ويتحدث أحد شخصيات في فيلم “معركة الجزائر” لجيلو بونتيكورفو: “كل شارع هنا له قلب ينبض، وكل زقاق قادر أن يثور”، لتغدو الحكاية أكبر من فرد، إنها تمثيل لذاكرة أمة أو لفعل مقاومة مفتوح.
وتتجلى سينما الاحتجاج في بحثها الدائم عن الحقيقة، في مواجهة الرقابة، وفي سعيها إلى نقل الغضب الشعبي دون تشويه، وفي معركتها مع السوق السينمائية التي تحاول تدجين الخطاب وإفراغه من راديكاليته؛ وتواجه سؤالاً أساسياً: كيف تحافظ على فنيتها دون أن تفقد قوتها الاحتجاجية؟ وكيف تظل صورة جمالية رغم أنها ولدت من رحم الألم؟ وكيف توفق بين بعدها الوثائقي الذي يوثق وبين بعدها الدرامي الذي يخلق مسافة للتأمل؟.
وتتأطر الخلفيات الفلسفية لهذه السينما بمنظور ماركسي يربط الفن بالصراع الطبقي، أو برؤية وجودية تسائل معنى الحرية في مواجهة السلطة، أو حتى بنزعة أنثروبولوجية تسعى إلى إعادة الاعتبار للهوامش المنسية. وتحضر أفكار فوكو عن المراقبة والعقاب، وتتردد أصوات سارتر وكامو في مواجهة العبث، كما تتسرب خطابات ما بعد الاستعمار في نقد الهيمنة الثقافية والاقتصادية؛ وترتكز الثقافة التي تسندها على إرث نضالي ممتد من التظاهرات الثورية إلى الشعر الغاضب والموسيقى المتمردة.
هوية المجابهة
ترتكب سينما الاحتجاج خيانة واعية للجماليات التقليدية، فتهشم السرد الخطي، وتوظف الكاميرا المحمولة، وتقترب من الملامح البشرية بشكل فاضح، وتترك المجال للصمت أن يصرخ أكثر من أي حوار، وتزرع الفوضى في المونتاج كي تعكس فوضى الشارع، وتستعين بلقطات وثائقية وسط السرد الدرامي كي تكسر الوهم السينمائي وتدعو المشاهد إلى وعي يقظ. وتتحول الموسيقى إلى نشيد احتجاجي، والإضاءة إلى ساحة مواجهة، والحركة البصرية إلى لغة غضب جماعي.
وتصوغ هذه السينما خطابها السردي بلغة المقاومة، حيث ينهض الراوي الداخلي أحياناً ليخاطب الجمهور مباشرة، أو حيث تتحول العناوين المكتوبة على الشاشة إلى بيانات سياسية. وينقلب البطل إلى أيقونة احتجاجية، يصرخ أو يُقتل أو يُعتقل، لكنه يظل صوت الجماعة الذي لا يُسكت. ويقول أحد أبطال فيلم “V for Vendetta”: “الأفكار لا تُقتل”، فيغدو النص السينمائي في ذاته فكرة عصية على الاندثار.
وتتمدّد سينما الاحتجاج عبر التاريخ الجغرافي والسياسي، من السينما الأمريكية التي فجّرت أسئلة الحرب والتمييز العنصري كما في أعمال سبايك لي، إلى السينما اللاتينية التي وثقت الثورات والانقلابات، إلى السينما العربية التي اصطدمت بالرقابة وهي توثق انتفاضات الشارع؛ وتتوسع لتصير عابرة للحدود، تصنع قوساً من المغرب إلى المكسيك، ومن طهران إلى نيويورك، ومن جنوب إفريقيا إلى فلسطين.
وتفضح هذه السينما في قصصها هشاشة الدولة حين تتحول إلى أداة قمع، وتكشف زيف الديمقراطيات حين تبيع شعوبها للرأسمال، وتعيد صياغة الذاكرة التاريخية كي تضع المظلوم في مركز الحكاية؛ وتلاحق المتن الحكائي الذي يتوزع بين شهادة الضحية، وصوت المقاومة، وصورة الجماعة، وتنسج شبكة من الحكايات الصغيرة التي تتراكم لتصير ذاكرة بصرية لثورات مهزومة أو لصرخات لم تجد طريقها للعدل.
وتعتمد الهوية البصرية لهذه السينما على المجابهة، فالألوان غامقة ومتدفقة، والكادرات تضيق كي تخنق المتلقي كما يخنق السجن أبطالها، أو تتسع كي تفتح الأفق أمام المظاهرات في ساحات عامة. وتتعمد الكاميرا أن تتعثر في حركتها، أن تقترب من العيون الدامعة، أن تنزل إلى الأرض حيث تسقط الأحذية في مواجهات الشارع؛ وتتبنى جماليات القبح كي تصنع صدمة، وتستثمر تفاصيل اليومي كي تعيد الاعتبار إلى المهمّش.
وتكمن قوة خطاب هذه السينما في قدرتها على طرح أسئلة مستمرة: كيف ينهض الفرد في وجه النظام؟ وكيف يتحول الجسد المقموع إلى جسد مقاوم؟ وكيف تصير الصورة بديلاً عن الصوت المغيّب؟ وكيف تتحول الحكاية الصغيرة إلى أسطورة احتجاجية تحفظها الأجيال؟.
وينهي أحد أبطال فيلم “Do the Right Thing”، “افعل الشيء الصحيح” (1989) للمخرج سبايك لي خطابه وهو يواجه الكاميرا: “حين ينهار الجدار لا تبقى سوى الحقيقة”، وكأن سينما الاحتجاج تعلن أن مهمتها ليست أن تمنح حلولاً، وإنما أن تضع الحقيقة في مواجهة الجمهور، مهما كانت موجعة.
وتستمر هذه السينما في فتح مساحات للمساءلة، وتدفع كل مشاهد إلى أن يتحول من متفرج سلبي إلى شاهدٍ ومشاركٍ في الحكاية، وتضع المشاهد أمام مرآة المجتمع، وتقول له إن الصورة ليست للمتعة فحسب، وإنما هي دعوة للفعل، لأن السينما حين تصير احتجاجاً تتحول إلى ذاكرة حيّة، إلى سلاح ناعم، وإلى صرخة لن تخفت.
البطل في سينما الاحتجاج: حامل الفكرة أكبر من حامل الجسد
يفتح توليد صورة البطل في سينما الاحتجاج أسئلة كبرى عن معنى البطولة في زمن الانكسارات، وعن قدرة الفرد على أن يصبح مرآة لصوت جماعي، وعن الكيفية التي تتحول بها الحكاية السينمائية إلى بيان يكتبه الغاضبون بدمهم. وانبثاق البطل هنا لا ينطلق من مركز القوة أو السلطة، وإنما من الهامش، ومن الشارع، ومن السجن، ومن جسد مسحوق ينهض كي يقول كفى. وتكشف صياغة هذه البطولة هوية جديدة للسينما، حيث لا تنحصر البطولة في الانتصار الفردي، بقدر ما تنحصر في قدرة الصورة على تجميع الطاقات الممزقة وإعلان موقفها أمام التاريخ.
ويشكل البطل في سينما الاحتجاج أولى محطات التحليل، إذ يتأرجح بين الفرد والجماعة، بين الأمل واليأس، وبين الانكسار والإصرار. ويتعرض البطل دوماً لمعضلة كبرى: كيف يوازن بين نجاته الشخصية وبين مسؤوليته تجاه الآخرين؟. في فيلم “معركة الجزائر” (1966) للمخرج جيلو بونتيكورفو يظهر البطل الشعبي كجزء من نسيج المدينة، يحمل صوته وصوت الحي بأكمله، ويعلن أن البطولة لا تنفصل عن الجماعة التي ينتمي إليها. ويتردد على لسان شخصية علي لابوانت قوله: “الحرية لا تُمنح، الحرية تؤخذ”، وهو تصريح يضع البطولة في خانة الفعل الجماعي لا الفردي.
وتكشف حساسيات البطل في هذه السينما توتراً دائماً بين الواقع والحلم، بين العنف والعدالة، وبين الصمت والكلمة؛ وتنبني ملامحه على قلق وجودي، فهو ليس بطلاً مثالياً، وإنما شخصية متصدعة تبحث عن معنى وسط الخراب. ويعيش البطل “موكي” في فيلم “افعل الشيء الصحيح” (1989) لسبايك لي حساسية مفرطة تجاه عنف الشارع والتمييز العنصري، ويجد نفسه ممزقاً بين صمته الذي قد يعني الخضوع وبين فعله الذي قد يشعل النار. ويقول أحد شخصيات الفيلم: “الغضب قد يحرقك، لكن الصمت قد يقتلك”، وهو قول يضع البطل أمام حتمية اتخاذ موقف مهما كانت كلفته.
وتتم صياغة رؤية البطل للعالم في سينما الاحتجاج من خلال التحديق في الواقع بلا مواربة. وينظر البطل إلى السلطة باعتبارها خصماً لا يتوقف عن القمع، وينظر إلى العدالة كحلم مؤجل، وينظر إلى الجماعة كملاذ أخير يمنحه شرعية وجوده. ويتجلى البطل في فيلم (Z) للمخرج كوستا غافراس من خلال شخصية النائب الذي يغتال بسبب مواقفه، ليصير موته بذاته صوتاً احتجاجياً. ويردد أحد المحققين: “القتلة لم يقتلوا رجلاً، قتلوا فكرة”، وهنا تتضح الرؤية التي تحكم البطل، إذ يصبح حامل الفكرة أكبر من جسده، فكرة قادرة على العيش بعد غيابه.
ويجري تمثل البطل لذاته عبر تصويره ككائن هش، مهدد، لكنه يصر على المواجهة، ولا يتماهى مع صورة البطل التقليدي الممسك بخيوط السيطرة، وإنما يقدَّم ككائن يخوض صراعاً داخلياً بقدر ما يخوض صراعاً خارجياً. وفي فيلم “V for Vendetta” (2005) للمخرج جيمس ماكتيغ يختار البطل القناع ليعلن تمثله لذاته كرمز، إذ يقول: “تحت هذا القناع أكثر من لحم ودم، تحت هذا القناع فكرة، والأفكار مضادة للرصاص”، وهو إعلان أن البطل هنا ليس فرداً وإنما هو صورة لوعي جماعي.
الاشتباك مع قضايا الفقر والبطالة والعنصرية
تتجلى الأبعاد الاجتماعية التي تحيط بالبطل في سينما الاحتجاج بالنظر في جذوره الطبقية والثقافية. وينتمي أغلب الأبطال في هذه السينما إلى الطبقات الشعبية والمهمشة، ويشتبكون مع قضايا الفقر والبطالة والعنصرية. وتتجلى هذه الأبعاد في فيلم Sorry We Missed You “آسفون فاتكم” (2019) للمخرج كين لوتش، حيث يتجسد البطل في رب أسرة محطم تحت ثقل نظام العمل الهش، ويقول: “نحن نركض كي نلحق بالحياة، لكنها لا تنتظرنا”، وهو تعبير عن سحق الأفراد اجتماعياً واقتصادياً تحت وطأة أنظمة غير عادلة.
كما أن البطل في البعد السياسي في هذه السينما هو دوماً خصم للنظام القائم، كاشف آليات القمع والرقابة. وفي فيلم The Square “الميدان” (2013) للمخرجة جيهان نجيم يظهر الأبطال كوجوه لثورة جماعية في مصر، ينادون بالحرية في مواجهة الديكتاتورية، ويردد أحدهم: “أردنا أن نصنع وطناً فاكتشفنا أن الوطن يُصنع بالدم”، وهو صوت سياسي يعري البنية القمعية للدولة ويجعل البطولة فعلاً سياسياً بامتياز.
ويقف البطل في البعد الاقتصادي دائماً في مواجهة قوى الرأسمال التي تستعبد الجسد وتبتلع أحلامه. وفي فيلم Modern Times “الأزمنة الحديثة” (1936) للمخرج تشارلي شابلن ينهض البطل الصامت ضد آلة الإنتاج التي تحول العمال إلى تروس بشرية، ويترنح بين خطوط المصنع لكنه يصر على الضحك في وجه القهر، لتتحول الكوميديا إلى احتجاج صامت.
ويفضح البعد النفسي في هذه السينما أثر القمع على الفرد، حيث البطل يتشكل ككائن مثقل بالقلق، ممزق بين الانخراط والخوف، محاصر بالعزلة لكنه مدفوع للأمام. وفي فيلم Taxi Driver “سائق التاكسي” (1976) للمخرج مارتن سكورسيزي ينفجر “ترافيس بيكل” تحت ضغط العزلة والاغتراب الحضري، ويصرخ في المرآة: “هل تخاطبني أنا؟”، وهو سؤال وجودي يضع النفس البشرية في مواجهة عالم غارق في العنف والتشيؤ.
سينما العين الساخطة والألوان الداكنة
يتحول البطل إلى أيقونة بصرية في البعد الرمزي لهذه السينما، حيث يغدو القناع، اللافتة، الصرخة، أو حتى الجسد نفسه رمزاً لقضية جماعية. وفي فيلم Selma “سلمى” (2014) لإيفا ديفيرني يصبح البطل مارتن لوثر كينغ رمزاً لمسيرة جماعية من أجل الحقوق المدنية، ويقول: “خطواتنا الصغيرة تصنع غداً كبيراً”، وهو قول يربط الفرد بالرمز الذي يتجاوز وجوده الشخصي.
وعلى مستوى الجماليات تعيد سينما الاحتجاج تعريف علاقة الجمال بالوظيفة. وتتحول الكاميرا إلى عين ساخطة، وتنقل الألوان الداكنة للقهر والبؤس اليومي، وتتماهى الموسيقى مع الهتاف والشعارات المكثفة، ويسرّع المونتاج إيقاعه ليحاكي الشارع؛ وتخرج هنا الجمالية من رحم الواقع، متوترة، خشنة، متعمدة أن تزعج المشاهد حتى لا يستكين.
كما أن البطل في الأبعاد النقدية في هذه السينما يتحدى المفاهيم السائدة عن البطولة، ويرفض تحويله إلى سلعة تجارية، ويخلق مسافة مع السرديات السائدة في السينما الهوليودية، وسينما السلطة والدعاية لها، ويعيد صياغة البطولة باعتبارها فعلاً جماعياً أكثر منها مغامرة فردية، ويضع الجمهور أمام مسؤولية المشاركة في الحكاية، فلا ينفصل عن القضايا المطروحة، بل يجد نفسه معنياً مباشرة بالأسئلة التي يطرحها البطل.
يؤكد الحديث عن البطل في سينما الاحتجاج أن هذا البطل لا ينتمي إلى أسطورة مغلقة، وإنما إلى ذاكرة مفتوحة تسكنها صرخات الجماهير وأحلامها المؤجلة. وتتقاطع الحكايات، وتتوالد الرموز، وتبقى البطولة هنا صوتاً حيّاً للغاضبين. ويقول بطل فيلم Les Misérables “البؤساء” (2019) للمخرج لادج لي: “تذكروا، نحن لسنا ذئاباً بلا قطيع، نحن قطيع يبحث عن عدل”، وهي فلسفة تلخص فلسفة البطولة في سينما الاحتجاج الشعبي.
















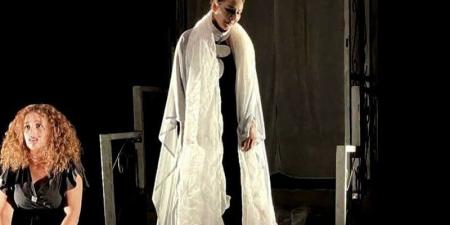

0 تعليق