خلص التقرير المتعلق بتقييم برامج محو الأمية الذي أعده مجلس النواب إلى أن هذه البرامج “هي على قدر متفاوت من الملاءمة مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والروحية والثقافية للمجتمع المغربي”، موردا أنه “تم الاهتمام أكثر بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك استحضار البعد البيئي؛ فضلا عن الحرص على الحفاظ على الأمن الروحي للمجتمع المغربي في هذه البرامج”.
وبالمقابل، أشار التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية بالغرفة البرلمانية الأولى، إلى وجود “محدودية فيما يخص جانب التمكين السياسي في أهداف هذه البرامج وكذا في الأبعاد الفنية والجمالية”.
وتطرق تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم “برامج محو الأمية” (الولاية التشريعية 2021-2026) إلى برنامج محو الأمية في المساجد، معتبرا أنه “نجح في استقطاب النساء اللائي يمثلن الشريحة الكبرى من المستفيدين بنسبة تفوق 85 في المائة في أغلب المواسم”، مبرزا أن ذلك “يعكس تجاوبا كبيرا مع البرنامج نتيجة ارتباط النساء اجتماعيا بالفضاءات الدينية للتعلم”، مشيرا إلى التوصل إلى “وجود تكامل بين التعلم الحضوري والتعلم عن بعد”.
ولفتت الوثيقة إلى أن البرنامج عن بعد يمثل “مكسبا إضافيا في ظل الطوارئ الصحية؛ وهو ما ينبغي تعزيزه ليصبح دعمة مستدامة للبرنامج”، متطرقة في السياق ذاته إلى “إشكالات في تغطية عالم القرى والمناطق النائية دائما بسبب ضعف البنية الطرقية وقلة المؤطرين المؤهلين”، ناهيك عن “صعوبات التنقل؛ مما يحد من فعالية البرنامج، ويهدد استدامته في هذه المناطق”.
وسجلت مجموعة العمل الموضوعاتية سالفة الذكر، كذلك، “ضعفا في استقطاب الرجال بسبب العمل الموسمي والهجرة الداخلية والثقافة السائدة حوله وصمة الأمية، رغم مجهودات الوزارة عبر الأئمة والأنشطة التحفيزية”. كما رصدت المجموعة أن “برنامج محو الأمية الوظيفة بقطاع الصيد البحري يواجه تحديات كبيرة أدت إلى تراجع كبير في عدد المستفيدين، حيث سجل انخفاضا حادا ما بين سنة 2021 و2023 بنسبة بلغة 65 في المائة”.
وأرجعت المجموعة ذلك إلى “خلل في جاذبية البرنامج أو في آليات تنفيذه بالإضافة إلى الإشكالية المتلازمة المتعلقة بالتنسيق في إعداد المشاريع”، فضلا عن “عدم مراعاة البرنامج لظروف البحارة من تنقلات ساعات عمل غير منتظمة وفترات طويلة في البحر مما يتطلب معه برنامجا مرنا وهو ما لم يتحقق”، موردة أن هذا “يفسر عزوفهم عن المشاركة”.
وبالنسبة لمعيار الفعالية، الذي “يعد من العناصر المحورية في تقييم السياسات والبرامج العمومية”، أشار التقرير، الذي قدمته نائبة مقررة المجموعة نادية بوزندفة، إلى أنه “تم التركيز على مدى تحقيق الأهداف المرجوة من برامج محول أمية بالإضافة إلى تقييم النتائج الملموسة التي ساهمت الأنشطة المبرمجة في تحقيقها، لا سيما ما يتعلق بتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى المستفيدين وتمكينهم أيضا من الكفايات الأساسية التي تعزز فرصهم في التعلم الذاتي والاندماج المهني”.
وذكرت المتحدثة، في كلمتها، أن “هذا التقييم لا يقتصر فقط على النتائج؛ بل يشمل أيضا تحليل مدى فعالية الاستهداف وجودة مضامين المقاربات التربوية المعتمدة والتحديات التي رافقت كافة مراحل تنزيل”.
وفي هذا الإطار، سجلت نادية بوزندفة مجموعة من الخلاصات؛ من بينها فيما يتعلق ببرنامج الوكالة الوطنية لمحو الأمية، بشراكة مع الجمعيات.
ووضح التقرير النيابي أن “هناك محدودية في الاستمرار بين المستويين “ألفا” و”بوسط ألفا”، حيث إن معدل الانتقال من المستوى الأول إلى الثاني لم يتجاوز 16 في المائة في أحسن حالته”، مشيرة إلى “تضخم الكم على حساب الكيف”.
وتابع المصدر عينه: “ففي بعض المواسم، ارتفعت أعداد الجمعيات والاتفاقيات بشكل لافت دون أن يقابلها تحسن مماثل في جودة التكوين أو الارتفاع في نسب الاستمرارية بين المستفيدين”.
ولفتت الوثيقة أيضا إلى “ضعف في استهداف الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق النائية والنائية جدا حيث تعجز الجمعيات عن تغطيتها بسبب ضعف الموارد أو اشتراط الحد الأدنى لعدد المسجلين”، علاوة على ذلك “تبقى فعالية نظام “سيمبال” محدودة؛ فعلى الرغم من دوره في تقليص بعض حالات الغش، فإن هذا النظام واجه انتقادات من الجمعيات بسبب صرامته وضعف مرونته؛ ما أثر على سلاسة تنفيذ البرامج ميدانيا”.
وأما على مستوى الحكامة فقد لاحظت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم “برامج محو الأمية”، خلال بعض زيارتها الميدانية، “ضعف التنسيق الترابي في ظل غياب فضاءات رسمية للمديريات الجهوية ومندوبيات الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية”، موضحة أن “العمل يتم من فضاءات غير رسمية؛ مما يؤثر على هيبة البرنامج ويضعف المراقبة والتنسيق المحلي”.
وبشأن برامج محو الأمية الوظيفية وخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، ذكرت المجموعة “التفاوت في توزيع المستفيدين من البرنامج بين المناطق الحضرية والقروية، حيث يظل الوصول إلى المناطق القروية محدودا بسبب صعوبة إيجاد جمعيات شريكة”.
وأبرزت أن “تنفيذ البرنامج يبقى متعثرا، ويعود السبب في بعض الأحيان إلى صعوبة في التنسيق بين الجهات المعنية وعدم تطابق الشروط المطلوبة مع الواقع؛ بالإضافة إلى التأخر النسبي في انطلاقه بسبب تأخر توقيع الاتفاقيات من لدن الإدارة المركزية في الوقت المناسب”.


















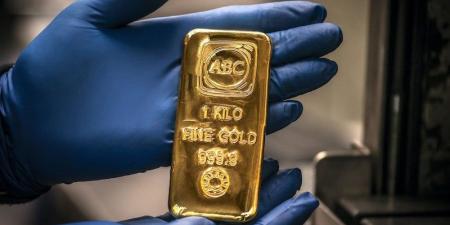
0 تعليق