ثمة كتابات تُدهشك لا لأنها تقول الجديد، بل لأنها تُعيد ترتيب المألوف بعيون مختلفة، فتجعلك ترى ما كنت تظنه شفافاً كغيم الظهيرة وقد اتّضح أنه مرآة مشروخة. رواية “الحب والحرب” للحسين العماني تنتمي إلى هذا النوع من الكتابة؛ كتابة لا تصرخ، بل تُفكّر بصوت خافت، وتتسلل إلى زوايا الثقافة الغربية دون ادعاء، مستبدلة الانبهار بالتحليل، والانصهار بالملاحظة المتأنية.
الرواية لا تحكي عن مغربي في نيويورك، ولا تضع العربي أمام “الآخر” الغربي في لحظة صدمة أو مواجهة، بل على العكس، تنسج حبكتها من الداخل الأمريكي نفسه، وتُجلس القارئ العربي على مقعد المشاهد ــ لا المشهَد ــ ليشاهد مسرح الحضارة الغربية وهي تُجرّب النظر إلى ذاتها في مرآة لا تمتّ للشرق بصلة.
الاستغراب، هنا، ليس تقليداً… بل تجربة نظر مختلفة
ليست نظرة المفتون بما لا يملك، ولا استعادة صوت منفيّ على أطلال المركزية الغربية، بل هو تأمل دقيق في عوالم السلطة، والمال، والرغبة، والانهيار الأخلاقي. كل ذلك يحدث من داخل السرد، ومن خلال شخصيات لا تحمل بصمة الشرق، ولا تلعب دور الضحية… وإنما تعيش تناقضاتها داخل نظام اجتماعي يعيد إنتاج أزماته بلا توقف.
الحسين العماني لا يقدّم الغرب كـ”يوتوبيا” أو “ديستوبيا”، بل ككائن حيّ، يتنفس قِيماً متناقضة، ويرتعش عند كل لحظة حب أو خيانة، طهر أو فساد. ولعلّ نيويورك في الرواية تجسيد مثالي لهذه الازدواجية: مدينة لا تنام، لكنّها لا تصحو بالكامل أيضاً، مدينة يتجاور فيها الحلم والكابوس، ويختلط فيها الحبّ بالتهريب، والمشاعر بالمصالح.
الرواية لا تحاكم، بل تُصغي
ومن خلال بطليها جيمس وكارا تُطرح أسئلة لا أجوبة جاهزة لها: ما جدوى القيم في عالم تذوب فيه الحدود بين الخير والشر؟ وهل للحب من مكان في واقع تحكمه الشركات العابرة للإنسان؟ ومتى يصبح النقاء الأخلاقي عبئاً بدل أن يكون فضيلة؟.
“الحب والحرب” ليس فقط عنواناً لرواية، بل استعارة لحالة سيولة أخلاقية يعيشها العالم المعاصر، حيث تتفكك المرجعيات، وتُجرَّب كل أشكال النجاة الممكنة، ولو كانت عبر العاطفة الهشة أو الجريمة المنظمة.
ما يقدّمه الحسين العماني، في النهاية، ليس روايةً فقط، بل اقتراحاً لرؤية
رؤية مغربية للغرب، لا تضع نفسها في موقع التابع، ولا تدّعي امتلاك الحقيقة؛ إنها كتابة تنبع من الإحساس بضرورة الفهم لا السجال، ومن الإيمان بأن الأدب يمكن أن يكون كاميرا نقدية، وعدسة التشريح العالم، لا مرآة لنقله. في كل سطر يرسم الحسين العماني درباً جديداً في سردنا العربي: لا شرق مسحور، ولا غرب مدهش… بل كتابة نقدية، واعية، تنفصل عن التبعية وتنمو من رحم التأمل، كزهرةٍ تفتحت على جدار الإسمنت.
بين شاشة وفكرة: الحسين العماني والرواية كجهاز كشف حضاري
في أزمنة تُستهلك فيها الثقافة الغربية على نحو يومي وسريع يقف الحسين العماني شاهقًا بين الكُتّاب المغاربة، لا كمجرد راصد لما يصدر عن الغرب، بل كعالم أنثروبولوجيا يمسك بالمجهر الافتراضي، متأملاً تفاصيل النموذج الأمريكي كما تُبَثّ وتُعاد صياغتها عبر منتجاته الثقافية؛ في روايته الحب والحرب لا يُظهر العماني فقط براعة في التخييل، بل يُعيد توجيه بوصلة التلقي، من تلقي الغرب ككيان متعالٍ إلى فحصه كمادة قابلة للفهم والتفكيك.
إن جملة بسيطة كـ”تعلمت ذلك من الأفلام” ليست سوى مفتاح سردي يُفتح به باب فلسفي: لقد استبطَنَ العماني المعنى العميق لـ”التمثيل”، وفَهم أن المجتمعات تقول عن نفسها أكثر بكثير مما تدّعي الصمت حوله. وما ترويه هوليود عن العالم ليس مجرد ترفيه، بل وثيقة غير رسمية عن اللاوعي الثقافي الأمريكي، ونقطة انطلاق لفهم الذات الغربية من داخلها.
الكاتب بوصفه عالمًا منزليًا في مختبر خياله
ما يقدمه الحسين العماني يتجاوز فُتات التصورات أو الاجتهادات المستعجلة، إنه يتعامل مع الرواية كما يتعامل باحث مختص مع فرضيته العلمية: يتحقق، يُجَرّب، ويراجع؛ إنه لا يعتمد على الخيال وحده، بل يطوّعه كأداة تحليل، ويمنحه انضباط التوثيق وجدية الرصد.
فحين يخلق مؤسساته البديلة لا يفعل ذلك ترفًا لغويًا، بل تعبيرًا عن موقف نقدي تجاه السلطة التمثيلية للرواية؛ فهو يدرك أن الحقيقة قد تكون أكثر صدقًا عندما يتم تخيُّلها بحرية، يبتكر أسماء جديدة تُشبه الأصل، لكنها تنحرف عنه قدر أنملة، بما يفتح أبوابًا أرحب للسيناريوهات الممكنة، ويمنحه الحق في اللعب على حدود الواقع دون أن يُؤخذ رهينة له.
الرواية كمرآة مزدوجة: الذات والآخر في آنٍ واحد
تجربة العماني لا تكتفي بكشف الغرب، بل تكشف تلقائيًا كيف ننظر نحن، كقراء وكمجتمعات، إلى هذا الآخر المهيمن؛ إنها تفضح ولعنا بنمطية النظرة، لكنها – في الوقت ذاته – تزوّدنا بأداة مقاومة: معرفة الآخر بدقة، وبوسائل غير تقليدية.
والأهم أنها تُحرر الرواية المغربية من كليشيهات الانبهار أو النقد الآلي، لتُدخلها في طور جديد: الطور الذي يكون فيه الكاتب حارس بوابة التمثيل الثقافي، لا المُنصاع له. وكأن الحسين يقول: أن تكتب عن الآخر لا يعني أن تغادر وطنك، بل أن تغوص أكثر في وعيك، أن تسافر بعينيك عبر آلاف الشاشات، وأن تضع الخيال في خدمة الحقيقة الممكنة.
إن مشروع الحسين العماني يشبه الخرائط الطيفية: ما تراه في الظاهر مجرد تضاريس روائية، لكن ما تُخفيه الأعماق هو خزان من التأملات والمعارف والرهانات الجمالية؛ لقد حوّل الرواية إلى جهاز لرصد الزمن، ومختبر افتراضي لفهم المجتمعات، ومنصة نقدية لإعادة النظر في دور الكاتب في زمن الشبكات والتمثيلات المركبة.
فهل آن لنا أن نقرأ الرواية كما نقرأ خرائط الجينات الثقافية؟ وهل يمكن لكاتب مغربي، دون أن يغادر أرضه، أن يُنتج معرفة عن العالم الآخر أدق من ابن البلد نفسه؟ في تجربة الحسين العماني الجواب لا يأتي كفرضية، بل كواقع ساطع… فقط لمن يُجيد الإصغاء إلى ما بين السطور.
الحب والسلاح: عندما يطرح الأدب أسئلة العالم من داخل التناقض
في قلب رواية الحب والحرب يقف القارئ أمام شخصية فريدة من نوعها: جيمس، شاب لطيف، وديع، لا يحمل من صفات الأشرار سوى المهنة التي اختارها… تجارة السلاح. ليس من أباطرة الحروب، ولا من أصحاب المصالح الكبرى التي تُشعل النزاعات، بل مجرد رجل طموح أنشأ مقاولة صغيرة، وبدأ تطوير أسلحة تقليدية بكميات محدودة؛ ومع أن مشروعه تطور وأصبحت منتجاته أكثر فتكاً ظل هو ذلك الشاب الهادئ الذي لا يحلم إلا بحياة مستقرة رفقة المرأة التي يحب.
هذه المفارقة وحدها كفيلة بأن تفتح باب التأمل أمام القارئ: هل يمكن للخير والشر أن يتجسدا في شخص واحد؟ وهل يمكن للنية الطيبة أن تُطهّر الفعل الخطر؟ وهل نحن فعلاً أحرار في خياراتنا ضمن منظومة عالمية تحكمها القوة والمال والسلاح؟.
قصة واحدة… قراءتان مختلفتان
في ظل عالم مضطرب، تعيش فيه البشرية جراح حروب دامية في فلسطين وأوكرانيا والسودان وغيرها، يطرح الحسين العماني من خلال هذه الرواية تحدياً كبيراً للقارئ، سواء كان في نيويورك أو في الدار البيضاء أو في دمشق. فالنيويوركي قد يرى في جيمس تجسيداً لحلمه الأمريكي الكلاسيكي: شاب يصعد السلم بذكائه واجتهاده، ويخلق تكنولوجيا جديدة في سياق سوق مفتوح. أما القارئ في العالم العربي أو الشرقي فقد يرى في القصة انعكاساً لتناقضات القوى الغربية التي تصنع أدوات الموت وتبكي على الضحايا.
هذا التوتر بين القراء، بين من يرى النجاح ومن يرى الخطر، هو ما يُعطي الرواية عمقها الحقيقي، ويجعلها نصاً قابلاً للانفجار التأويلي؛ فكل قارئ يجد نفسه مجبراً على التوقف عند لحظات في السرد، ليطرح على نفسه أسئلة وجودية وأخلاقية عميقة: ما حدود الطموح؟ متى يصبح الابتكار خطراً؟ وهل من الممكن أن نفصل الإنسان عن أفعاله؟.
رواية تدفعك إلى التوقف… لا إلى الهروب
قوة الحب والحرب لا تكمن فقط في حبكتها المحكمة أو تقنياتها السردية المتقنة، بل في قدرتها على دفع القارئ إلى التوقف، لا للهروب أو التسلية، بل للتفكر وإعادة صياغة الأسئلة؛ إنها رواية تشبه مرآة مزدوجة: كلما تعمقت في شخصياتها انعكس وجهك، بأسئلتك، على سطحها.
الرواية تخلخل التصنيفات الجاهزة، فالمجرم ليس مجرماً بشكل تقليدي، والمحب ليس بريئاً دائماً، والحياة لا تُختزل في الأبيض والأسود؛ إنها رواية تقترح علينا أن ننظر إلى العالم بتعقيده لا بسطحيته، وأن نعيد النظر في ما نعتبره “طبيعياً” أو “مبرراً” أو “عادلاً”.
بفضل شخصية مثل جيمس يتمكن الحسين العماني من ممارسة نقد اجتماعي وفلسفي عميق دون أن يرفع شعارات مباشرة؛ فالرواية لا تعظ القارئ، بل تجرّه بهدوء إلى أعماق الأسئلة، وتجعله يشك في بداهاته.
الحب والحرب ليست مجرد قصة عن رجل وامرأة وسط عالم مضطرب، بل ورشة تفكير أخلاقي وسياسي وجمالي، تجعل من الرواية فناً يعيد ترتيب علاقتنا بما نعيش، وما نرفض أن نراه.
شاعر وناقد












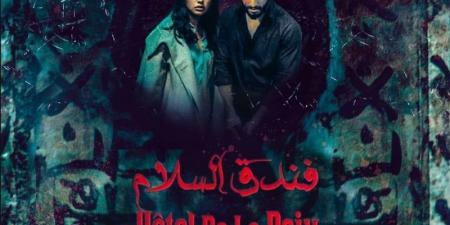
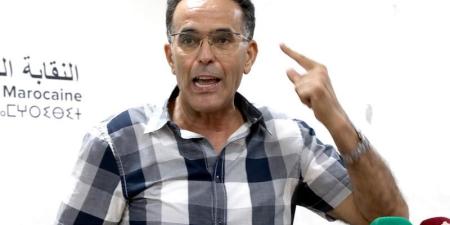


0 تعليق